مفكر فرنسي يتنبأ بنهاية هوليوود وانتصار الفن الحقيقي

يرى فرانسيس بوردا أن السينما فضاء للحرية، وشكل من أشكال المقاومة الفنية والجمالية لكل الأفكار المسبقة والمواضعات، ومختلف أشكال الدكتاتوريات. ويقترح المفكر والناقد السينمائي الفرنسي فرانسيس بوردا، في هذا الحوار الخاص مع “العرب”، أن يكابر السينمائيون في العالم العربي وأوروبا في سبيل مواجهة كل جهة سولت لها نفسها استغلال السياسة أو الدين، أو أي سلطة أخرى، من أجل سلب الحريات ومنع المتوسطيين والمتوسطيات من التنقل بحرية والعيش بكرامة على ضفاف المتوسط، بما هو فضاء لميلاد الفنون والإبداعات، قبل أن يكون فضاء لإمبراطوريات القمع والاستعباد والاضطهاد، ثم ما بعدها منطلقا للأنوار والحريات.
ينطلق المفكر والناقد السينمائي الفرنسي فرانسيس بوردا من السينما، باعتبارها “أهم اختراع إنساني ينشد الحرية ويجسدها، ماثلة أمام الناس، شاخصة أمام أبصار العالم”. ويشدد الأستاذ في جامعة باريس العاشرة على أن الفن نظير الحرية، ولذلك، فهو “يتمرد على كل شيء، بل حتى على نفسه، مثلما يعلن تمرده على القواعد التي تنتظمه بفعل تراكم الممارسة الإبداعية”. أبعد من ذلك، يذهب محدثنا إلى أن “الفن الحقيقي، سواء أكان قصيدة أم فيلما سينمائيا، أم مسرحية، هو الذي يتمرد على جمهوره وقرائه، ويخرق أفق انتظاراتهم وتوقعاتهم”. وانطلاقا من ذلك، فإن ما يسميه بوردا “فن الحرية” هو الذي من شأنه أن “يستفز النقاد أنفسهم، ومنظري الفن، ويدعوهم إلى تجديد قراءاتهم والتخلي عن أحكامهم الجاهزة وأعرافهم وعاداتهم ومناهجهم في طرائق التحليل ومسالك المقاربة”.
وعموما، فإن الفن هو نقيض كل الخطابات الجائزة، والتي تتعالى عليه، وتدعي معرفة يقينية أو حقيقة سابقة على الممارسة والتجربة الإنسانية في مستجد الحياة. ولذلك، يرى بوردا أن أول خطاب قد يتهدد السينما ويحد من سقف أحلامها المفتوح هو الخطاب الإعلامي، ما دام يتنازع السينما ويتقاسم معها الشاشات المرئية وهي تتوجه إلى عموم المشاهدين، ما لم يستند هذا الخطاب الإعلامي نفسه لفضيلة الحرية، وقيم الاختلاف، والحس النقدي الخلاق.
والسينما شأنها شأن باقي الفنون لا تقف في مواجهة وسائل الإعلام، بل في مواجهة كل الأفكار المسبقة والمواضعات والعادات والدكتاتوريات على أساس أن “انتقال الأفكار والمشاعر يجب ألا ينتصب في طريقه أيّ إكراه وعائق”.
وهنا، يخبرنا بوردا “عندما أذهب إلى السينما، أسعى في نفس الوقت إلى العثور على ذاتي (البحث عما يتخفى داخلي)، وإلى الاغتراب عن ذاتي، سعيا إلى الالتقاء بما ليس أنا، أو ما أعتقد أنه ليس أنا، ولكنه في الواقع شيء مشترك بين الناس. وفي كل الحالات، أذهب إلى السينما لمقاومة الأفكار الجاهزة والمكرورة”.
نهاية هوليوود
انطلاقا من مجال تخصصه في السينما المقارنة، وهو أستاذ كرسي الحضارة الأميركية في جامعة باريس العاشرة-نانتير، انشغل فرانسيس بوردا، في أبحاثه الأكاديمية، بدراسة التاريخ الاقتصادي والسوسيو-ثقافي لهوليوود. وقد صدرت له عدة مؤلفات ودراسات حول السينما الأميركية والعالمية، أهمها “شابلن السينمائي”، و”مئة سنة من ارتياد السينما: الفرجة السينمائية الأميركية 1896-1995″ و”ووسائل الإعلام في فرنسا: التأثيرات والاختراق”.
وعن مقارنة السينما الأميركية بالسينما في بلداننا المتوسطية، يرى بوردا أن “أن لا شيء ‘ينقص’ السينما المتوسطية، على وجه الخصوص مقارنة بالسينما الأميركية. فهي سينما ما انفكت تفقد بوضوح، على الأقل، منذ العشرين سنة الأخيرة، زخمها الإبداعي”. والحال أن “أهم الأفلام وأكثرها تجديدا وإبداعا، التي شاهدتها خلال العشر سنوات الأخيرة، ما عدا بعض الاستثناءات، ليست أميركية، بل هي أفلام أوروبية (من إسبانيا إلى رومانيا)، ومن باقي بلدان العالم (الصين وتركيا ومصر وكوريا وإيران ومالي وغيرها)، وهي في أغلب الأحيان من إنتاج مشترك مع فرنسا”. وهنا يذكرنا المتحدث بأن نظام دعم الإبداع في أميركا هو الذي يلعب دورا أساسيا في ضمان استمرارية الفن السينمائي على المستوى العالمي. بينما تخصصت هوليوود، تقريبا، في إنتاج أعمال سينمائية دولية بميزانية ضخمة، وهي أعمال نمطية وخاضعة لمعايير مسبقة، مما يجعل بعدها التجديدي منحصرا في الحيل والتأثيرات الخاصة التي لها جمهورها. كما يرى بوردا أن “إبداعية المؤلفين الأميركيين انصبّت بالتالي على المسلسلات التلفزيونية التي غذت اليوم في نظري أهم بكثير من عروض الشاشة الكبيرة”. وهو ما ينذر، حسبه، بنهاية سينما هوليوود، والانتقال إلى عصر المسلسلات التلفزيونية التي تجري صناعتها وفق الذوق الأميركي.
صناعة هوليوود
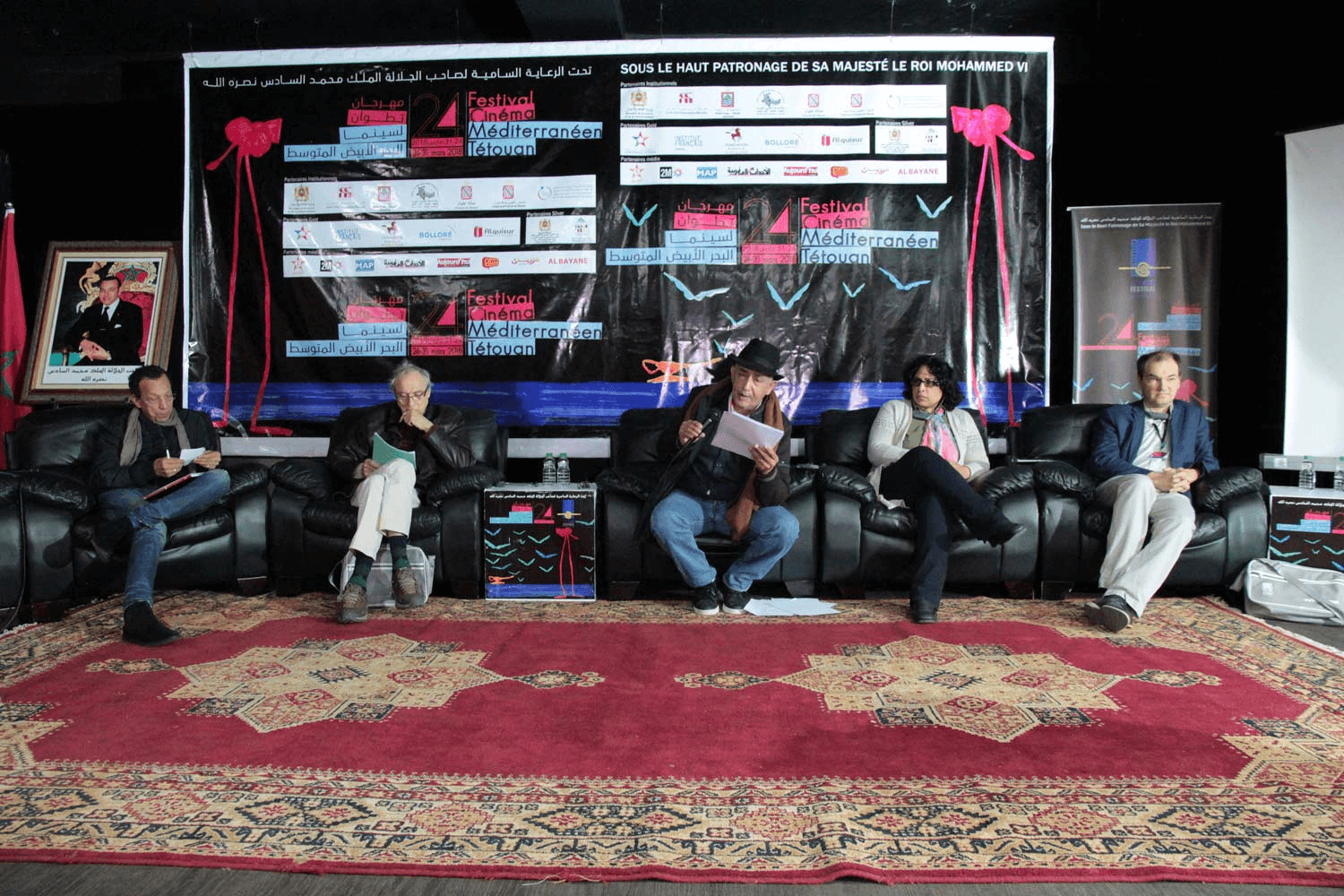
إذا كانت السينما فنا متقدما ومتحررا، فهي صناعة أيضا، يؤكد المتحدث. وهو يرى أن تطور الصناعة الهوليوودية هو الذي مكن من تكوين جمهور عريض لا يزال يرتاد دور السينما، مثلما مكن من ضمان مردودية مجزية، أدت بدورها إلى دعم التطور الهائل لتكنولوجيات الفن السابع. كما مكن إنشاء الأستديوهات في بداية القرن العشرين من تشكيل أسلوب “كلاسيكي”، هو أسلوب الفيلم “السردي” بمواصفاته الفنية الخالصة التي لا يمكن إنكارها. غير أن “هوليوود لم تتحول إلى عاصمة للسينما العالمية إلا بعد استقطابها للمواهب والكفاءات من مختلف دول العالم”. كما لا ننسى أن هوليوود ظلت دائما نوعا من “المجتمع الدولي المختلط” الذي يتغذى من طاقات وموهبة الآلاف من المهاجرين، يضيف بوردا، وهو يحذرنا من “الخلط بين هوليوود والولايات المتحدة الأميركية، وخاصة، هذه التي يحكمها السيد دونالد ترامب!”. مثلما يبقى من الصعب أيضا تصور هوليوود كنموذج للسينما العالمية، ذلك أن “الأساس الاقتصادي الذي تقوم عليه هذه السينما غير قابل للاستنساخ”، ووحدها السينما الهندية ممثلة في بوليوود تقترب من ذلك النموذج. كما أن تقليدها هوليوود لن يؤدي، في نظر المفكر الفرنسي إلى “تلبية حاجيات الجماهير في مختلف الأوطان وتطلعها إلى الأصالة والتنوع، حتى وإن كانت هذه الجماهير تستهلك الإنتاجات السينمائية الضخمة”.
سينما حرة
ينادي فرانسيس بوردا بما يسميه “سينما حرة”، بقدر ما نطالب بضمان حرية الإعلام. وهو يرى بأن الإعلام يجب أن يصطف إلى جانب السينما في نشدان الحرية وإشاعة روحها في حياتنا. ولا يعتقد محدثنا أن تحدث وسائل الإعلام تأثيرا سلبيا على السينما، “ما عدا في تلك الحالات التي تكون فيها السينما خاضعة لأنظمة استبدادية تسعى إلى تحويل السينما إلى وسيلة للدعاية”. أما وسائل الإعلام الحرة التي تواكب بالنقد سينما حرة فلا يمكنها سوى أن تتفاعل إيجابا معها، مما ينعكس إيجابا عليهما معا.
في هذا السياق، يقر بوردا بأن حرية وسائل الإعلام مسألة أساسية، ويجب أن يصاحبها شعور ضروري بالمسؤولية. وعلى غرار الأفراد، فإنها مؤطرة بمجموعة من القوانين التي تضمن الحريات وتنظمها. و”بما أن السينما فن، فحريتها من باب أولى أكثر ضرورية، ذلك أن الفيلم، مثله مثل الرواية والشعر واللوحة الفنية، يجب أن يقول كل شيء، بما في ذلك الأمور التي تصدم المتلقي. وبهذا الشرط وحده يمكن الاستفادة من السينما”، تلك السينما الحرة، التي ينادي بها فرانسيس بوردا، والتي تستدعي مشاهدا يعانق هذه الحرية أيضا، وناقدا متحررا هو الآخر من كل الخلفيات والأحكام الجاهزة، مواكبا لأحلام السينمائيين بخيال نقدي مجنح، وأفكار خلاقة.
