العرب في الثقافة الفرنسية

تزخر الساحة الفرنسية بكتّاب وشعراء وباحثين ومفكرين وعلماء اجتماع فرنكفونيين من أصول عربية، منهم من رسّخ اسمه منذ سنوات مثل فينوس خوري غاتا وألبير ممي وليلى صبار وطاهر البكري وخاصة أمين معلوف عضو الأكاديمية الفرنسية، وطاهر بن جلون عضو أكاديمية غونكور؛ ومنهم من سجّل حضورا لافتا في الأعوام الأخيرة. بعضهم داوم النشر في الدور الفرنسية دون أن يغادر بلاده مثل رشيد بوجدرة وأمين الزاوي وعبد لحق سرحان وشريف مجدلاني وإسكندر نجار وليلى مروان والحبيب طنغور، وبعضهم مقيم في فرنسا كسليم باشي وفوزية الزواري وليلى سليماني وصابر المنصوري وكوثر عظيمي؛ أما الباقون فهم من الجيل الثاني من أبناء المهاجرين، أمثال نينا بوراوي وعقلي تاجر وعزوز بقاق ومهدي شارف وأليس زنيتر التي كادت روايتها الأخيرة “فن الفقدان” تفوز بجائزة غونكور في دورة هذا العام.
أولئك جميعا صاغوا ولا يزالون يصوغون أعمالا جديرة بالنقد والدراسة، ولكننا آثرنا التوقف عند زملائهم ممن أثروا الساحة الفرنسية هم أيضا، إيثارا يستند إلى ثلاثة عناصر: قيمة المنجز الأدبي والعلمي، الحضور البارز في المحافل العلمية والثقافية والإعلامية، وسعة الانتشار، فضلا عن إصدارهم عملا جديدا خلال السنتين الأخيرتين.
عبدالنور بيدار وأمراض الإسلام
بعد رحيل مالك شبل وعبدالوهاب المؤدب، واصل المفكر عبدالنور بيدار الدفاع عن الأنوار في الفكر الإسلامي، والدعوة إلى العلمانية لإنقاذ الدين من مخالب المتاجرين به، وتقديم الجوانب المشرقة في الحضارة الإسلامية التي ما بلغت شأوا عظيما إلا عند إقرار التسامح بين الأديان، ويحذّر مما يسميه “أمراض الإسلام” داعيا إلى ديانة منفتحة، حديثة، قادرة أن تطرح أسئلة على نفسها، سواء من خلال مقالاته بمجلة “فكر” أو بجريدة “لوموند”، أو عن طريق برنامجه “ثقافات الإسلام” بإذاعة فرنسا الثقافية الذي ورثه عن الفقيد المؤدب، أو عبر مؤلفاته العديدة أمثال “كيف السبيل للخروج من الدين” و”الإسلام الذاتي” و”رسالة إلى العالم الإسلامي” وهي رسالة مفتوحة كان نشرها في موقع مجلة “ماريان” بعد العمليات الإرهابية التي ضربت باريس، وترجمت إلى اللغتين الإنكليزية والعربية، دعا فيها المسلمين إلى النقد الذاتي، كما دعا إلى إسلام متحرر من الخضوع والعنف، قادر على نشر حرية المرأة وتفتحها وإرساء الديمقراطية ونقد المسألة الدينية.
ولئن بيّن في كتابه “مرافعة لأجل التآخي” أن من الصعب أن نجتمع حول “ملكية مشتركة” أخلاقية وسياسية وروحية، فإنه يتساءل في كتابه الأخير “أيّ قيم نتقاسم وننقل” عن القيم التي تجمعنا، فعدّد منها ثلاثين قيمة جوهرية، ليؤكد أن مختلف الموروثات الإنسانية للشرق والغرب، سواء أكانت أدبية أم فلسفية أم دينية، تقدم لنا عناصر أجوبة تتصل بالتساؤلات الكبرى للوضع الإنساني: ما معنى أن يكون المرء أخويا، متعاطفا، عادلا، مستقيما، متسامحا، شجاعا، ذا وعي نقدي، منمّيا إحساسه بالجمال، عظيما في إنسانيته؟ ويرى أن دروس التربية المدنية والأخلاقية لا تفي وحدها بالغرض، إلا إذا اتفقنا على المعنى المقصود بالأخلاق، حتى لا يفسره من يشاء كما يشاء.
محمود حسين والدعوة إلى إعادة قراءة القرآن
محمود حسين هو الاسم الذي اختاره المصريان بهجت النادي وعادل رفعت، عالما الأنثروبولوجيا وتاريخ الأديان لتوقيع عدة مؤلفات من أهمها “تصور القرآن” و”ما لا يقوله القرآن”، وكان قد سبق لهما إعداد سلسلة تلفزيونية وثائقية من اثنتي عشرة حلقة بعنوان “عندما كان العالم يتكلم العربية”، استعرضا فيها مسيرة الحضارة الإسلامية منذ فجر الإسلام. آخر ما صدر لهما كتاب بعنوان” المسلمون وتحدي داعش” بيّنا فيه كيف أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن الحرب على الأنسنة الحديثة وادّعى أنه يأتي ذلك بدعوى العودة إلى إسلام الأصول، وبذلك تحدّى المسلمين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إدانته أخلاقيا وإنكار دعوته فقهيا لكي يخلعوا الشرعية عن خطابه. فإن فعلوا وضعوا المعتقد نفسه موضع مساءلة، وهو الذي يقول إن القرآن هو كلام الله، وإن كل آياته غير قابلة للتقادم. والكاتبان يؤكدان أن ذلك الاعتقاد ليس نابعا من القرآن بل من فرضية أولية أيديولوجية ألصقت بالقرآن منذ وفاة الرسول، تناقضه من كل ناحية. فكلام الله يقدّم على أنه حوار بين السماء والأرض، ويمزج الروحي بالظرفي، ويختلط بالمعيش اليومي للمسلمين الأوائل في شبه الجزيرة العربية إبان القرن السابع الميلادي، أي أن جانبا منه متصل اتصالا وثيقا بمرحلة غابرة. ولا يمكن تبعا لذلك التقيد بالآيات الوصفية والحربية منها على وجه الخصوص، لأنها مرتبطة بزمن معين ولّى وانقضى. وفي رأيهما أن رفع تحدي داعش على المستوى العقدي يمكن أن يمثل لكثير من المسلمين فرصة لاستعادة حرية الضمير وفكّ عقدة المعتقد.
علي بنمخلوف والإرث الإنساني المنسي

هو فيلسوف تحليلي، متخصص في الفلسفة العربية في القرن الوسيط، وفي مناطقة القرن العشرين أمثال البريطاني برتراند راسل والألماني غوتلوب فريغه والأميركي ألفريد نورث وايتهيد. عرف عنه، إلى جانب تدريس الفلسفة في جامعة باريس الشرقية، نشاطه في الحياة العامة، إذ يرأس الهيئة الاستشارية لأخلاق المهنة والإيتيقا في معهد البحث من أجل التنمية، ويشغل منصب رئيس مساعد للهيئة الاستشارة القومية للإيتيقا. من مؤلفاته “ابن رشد” و”فريغه، الضروري والزائد” و”الهوية، خرافة فلسفية” و”لماذا نقرأ الفلاسفة العرب-الإرث المنسي” وأخيرا ” النقاش كأسلوب حياة”، وفيه يبين كيف أن النقاش يصل الناس بعضهم ببعض عن طريق الكلام، وهذا الرابط يمرّ عبر الصوت والنفَس والنظرة ووتيرة الصمت والحركات. ويستشهد بمونتاني الذي كان يقول عن التحاور والتناقش “نحن بصدد كيفية القول، لا مادة القول”. وفي رأي الكاتب أن النقاش ليس استدلالا، بل هو كلام في طور الحركة، وليس حكمة جاهزة بقدر ما هو أسلوب حياة. وعلى غرار مونتاني أيضا يستكشف الكاتب الثراء الكامن في الانعطافات والاستطرادات والكلام المتقطع الذي يوقظ الأذهان. ويستقرئ الأدب من فلوبير إلى سان سيمون ولويس كارول وبروست، في نقاش داخلي صامت، مع المؤلف الذي اندثر، والكتاب الذي بين يديه، أو الذي يرقد جنبه، ليستخلص في النهاية أن في النقاش مخاطر، خطر العلاقة التي قد تربط المرء بهذا أو ذاك، وخطر المجهول الذي يحملنا إليه ذلك النقاش الفكري بالأساس.
انطلق بنمخلوف في كتابه هذا من نقطتين: اهتمامه بفلسفة اللغة والأعمال اللغوية، وهو ما استلهمه من قراءته لمونتاني، إذ أحس أنه يتناقش مع المؤلف، أي يقوم بتلك الرحلة التي يعتبرها ديكارت هامة في قراءاته. ويعترف بأن مونتاني فتح أمامه بوليفونية النقاش وساعده على إعادة قراءة التراث العربي الإسلامي عن النقاش العالم، وطريقة التعرف على أهمية الإرث اليوناني ومقارنة منطق أرسطو بالنحو العربي.
فتحي بنسلامة وتفكيك أسطورة المسلم فوق العادي
من الوجوه الحاضرة في الساحة الإعلامية، إذ عادة ما يسأل عن رأيه في القضايا الساخنة التي تشغل الفرنسيين بوصفه متخصصا في التحليل النفسي، ومهتما بالمسألة الدينية ومظاهرها الراديكالية، وخاصة بالإسلام وعلاقته بالأصولية، وقد نشر عدة مؤلفات نخص بالذكر منها “التحليل النفسي واختبار الإسلام” و”رغبة جامحة في التضحية” الذي استعمل فيه مصطلح “المسلم فوق العادي” ضمن تحليله لشتى أشكال التطرف باسم الإسلام. هذا المصطلح، الذي استوحاه من نيتشه وإنسانه الأسمى “Übermensch”، ينطبق على كل من يستجيب عن غير وعي في الغالب لحتمية ذات آثار رهيبة، وهي ظاهرة انتشرت خلال القرن العشرين، حيث صار المسلم يرغب بقوة في أن يصبح مسلما غير عادي، فينتقل من الأصولية التي يفترض أنها سلمية إلى الجهادية والعنف، والحال أن عبارة “مسلم” تحمل معاني سامية تحيل على التواضع والخشوع. تلك الحتمية ربطت وفاء المسلم وكرامته بسلوكيات تقتضي منه أن يقوّي إيمانه درجات عن طريق إيذاء أخلاقي تجاه ذاته وقسوة تجاه الآخر، لكي يُظهر عظمته ككائن لا يُقهر بوصفه مسلما أولا وأخيرا، من خلال زبيبة على الجبين والصلاة على قارعة الطريق وتميز في الهيئة والهندام يبديها كعلامات تشهد بقربه من الله. هؤلاء المسلمون فوق العاديين صاروا ينطقون باسم الله وينفثون كرههم على كل من ليس له إيمان صلب كإيمانهم، حتى من ينطقون الشهادة مثلهم. وعبارة “الله أكبر” التي يفترض في قائلها التواضع أمام عظمة الخالق تحولت في أفواه تلك الفئة إلى صيحة قتل وذبح، أي أنها في النهاية صارت ازدراء بالحياة وتمجيدًا للموت.
في كتابه الأخير “جهادية النساء” يلتقي مع فرهاد خوسروخوار عالم الاجتماع لتطارح مسألة انجذاب النساء إلى الفكر الداعشي والعوامل التي دفعتهن إلى الالتحاق بصفوف هذا التنظيم الإرهابي، لا سيما أن عددهن قارب عدد الرجال الذين غادروا أوروبا ليلتحقوا بجبهات القتال. واستنادا إلى المعطيات الاجتماعية والتحاليل النفسية يقترح المؤلفان تحاليل تقوم على معايير موضوعية كالسن والطبقة الاجتماعية ومكان الإقامة والتكوين الإسلامي أو الدخول في الدين.. ثم يسلطان الضوء على الاعتبارات الذاتية لتفسير الانضمام إلى ذلك التنظيم العنيف الذي ينكر على المرأة حريتها وتفتحها، ويوهمها بتحقيق ذاتها كزوجة مقاتل وأمّ أشبال منذورة للقتال بدورها مثل زوجها حتى الموت. ويهتم المؤلفان بتفسير قوة الجذب التي يشكلها الفكر الداعشي كعلامة على تدنّ حضاري لم تفلح المدرسة والمجتمع الغربي في التنبه إليه.
بيير رابحي المزارع الفيلسوف

حياة بيير رابحي رواية في حدّ ذاتها. هو مواطن جزائري الأصل يدعى رابح رابحي، ولد عام 1938 في واحة كنادسة بولاية بشار، توفّيت أمه وهو طفل فعهد أبوه بتربيته لعائلة فرنسية تبنّته وأخذته معها إلى وهران حيث علّمته ونصّرته فصار اسمه بيير. ولما اندلعت الثورة عام 1954 ألفى نفسه مطرودا من الجهتين: من أبيه الذي لم يغفر له تنصّره، ومن أبيه بالتبنّي الذي لم يغفر له انتقاده للماريشال جوان. فسافر إلى فرنسا حيث اشتغل عاملا في مصنع تعرّف فيه على ميشيل فتزوجها رغم رفض أهلها، وقررا معا مغادرة المدينة والاستقرار في أحد الأرياف. وصادف الزوجان طبيبا إيكولوجيا كان يستعد لإنشاء منتزه وطني بمنطقة سيفين، فشجعهما على خوض التجربة. استقر بيير مع زوجته في منطقة صخرية قاحلة ليس فيها كهرباء ولا ماء صالح للشراب ولا طريق معبدة، ولم تكن له خبرة بالفلاحة ولا بتلك الدروب الوعرة، ولكنه صمد وبدأ يشتغل في إحدى الضياع كعامل فلاحي قبل أن يستقل بنفسه ويشرع في تربية الماعز، ويعتمد على الزراعة الحركية الحيوية، ولم يصبح قادرا على تحقيق الاكتفاء الذاتي إلا بعد مرور خمسة عشر عاما من الجهد والصبر والمثابرة. عندئذ صار ينصح بدوره بقية المزارعين ويرشدهم إلى ما ينبغي القيام به على مدار العام. وسرعان ما راج خبر هذا المزارع العربي الذي حوّل أراضي جرداء إلى حقول ومزارع خصيبة، فصارت المحافظات الفرنسية الأخرى تستدعيه ليأخذ بيدها، وصارت الدول، في أوروبا وأفريقيا والمشرق والمغرب العربيين، تستقدمه لتعميم تجربته في أراضيها، لا سيما أن طريقته تعتمد على تطوير الأعمال الزراعية التي يقدر عليها حتى المعدمون والفقراء، واستعانت بخبرته حتى منظمة الأمم المتحدة للحدّ من التصحر.
ورغم الجهود المبذولة كان رابحي يجد الوقت للقراءة والكتابة، فألف وحاور وأنتج حتى صار قبلة الفلاسفة من إدغار موران وتيودور مونود إلى ألبير جاكار وجاك بروس وكونت سبونفيل علاوة على رجال السياسة ونواب الشعب الذين يحجون إليه ليطّلعوا على ما حققه في المجال الفلاحي، ويحاوروه حول فلسفته التي استمدها من الهندي جدّو كريشنامورتي (1895-1986)، والنمساوي رودولف شتاينر (1861-1925)، لا سيما من جهة استعمال الزراعة الحركية الحيوية المتأتية من الأنتروبوسوفيا وهي فلسفة باطنية طورها شتاينر في عشرينات القرن الماضي.
دنيا بوزار ومعالجة تشدد المراهقين
هي عالمة أنتروبولوجيا من أصل جزائري، اختارتها حكومة الاشتراكيين في عهد مانويل فالس لوضع خطة تستهدف علاج المراهقين المتشددين الذين عادوا من جبهات القتال أو كانوا يستعدون للالتحاق بها. ولكنّ أساليبها لم تنل رضا المعارضة اليمينية وحتى زملائها من الوسط العلمي والفكري، فكانت دائما في صراع مع من يشكّون في قدرتها على إيجاد حلول لنزوع الشبيبة إلى التشدد، ويتندرون باسمها وأصولها؛ كما أن مواقفها المعلنة من تنظيم داعش جعلتها قبلة سهام الأصوليين الراديكاليين، حتى صارت تعيش وتتنقل تحت حماية أمنية. بيد أن ذلك لم يثبّط عزمها على تحليل الأسباب التي ساهمت في تنامي تلك الظاهرة ووقوع المراهقين بسهولة في شراك المروّجين للفكر الداعشي. وهو ما طرحته في كتابها الأخير “كنت أحلم بعالم آخر”.
في هذا الكتاب تحاول بوزار بمعية سيرج هيفيز، عالم التحليل النفسي المتخصص في مشاكل المراهقين والعلاج النفسي العائلي، تفكيكَ الأساليب التي يعتمدها مجنِّدو تنظيم الدولة الإسلامية، والوقوف على المسار الذي ينتقل عبره المراهقون إلى الراديكالية. والإجابة التي ما فتئ الفرنسيون يطرحونها بعد أن عمّت الظاهرة وعادت عليهم بالوبال: ماذا يحدث في ذهن شاب مستعد للمجازفة بحياته؟ كيف وصل إلى هذا الحد؟ لماذا افتتن بخطاب داعش المتطرف؟ ما الذي يدفعه إلى قطيعة راديكالية مع كل ما كان يمثل حياته حتى تلك اللحظة؟ عندما يلغي الشاب المجنَّد عائلته ليتجه إلى عائلة أخرى، ويستبدل المحاكاة والتكرار بالعقل ويجعل الجماعة تفكر عوضا عنه، ويفقد كل إحساس تجاه الناس جميعا، ويقبل أن يَقتل ويُقتَل، فكيف السبيل عندئذ إلى إعادته إلى الرشد، حتى يشعر أنه فرد بذاته يملك قراره؟ وهي إذ تتساءل عن الحدّ الفاصل بين الهشاشة التي ترافق المراهقة والانخراط والتزمّت والتشدد والجنون القاتل، تعقد الأمل في إمكانية تعافي الشبان حتى يستعيدوا حرية التفكير بأنفسهم.
ياسمينة خضراء
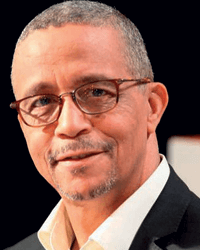
هو أغزر الكتاب الفرنكفونيين إنتاجا وأكثرهم انتشارا، ولكنّ ماضيه العسكري كضابط سابق في الجيش الجزائري، ثم موالاته للنظام الذي عينه مديرا للمركز الثقافي الجزائري بباريس (من 2008 إلى 2014)، ولّدا عنه صورة مثقف السلطة وحرماه من جائزة غونكور في أكثر من مناسبة، ولم يفز إلا بجوائز ثانوية، رغم توسيمه من الأكاديمية الفرنسية ومن الجمهورية نفسها.
بدأ النشر باسمه الحقيقي محمد مولسهول حينما كان في الجزائر، ثم صار ينشر تحت أسماء مستعارة تجنبا لهيئة الرقابة العسكرية، من بينها ياسمينة خضراء على اسم زوجته، وهو الاسم الذي اختاره منذ 1997 عند نشر أول كتاب في فرنسا بعنوان “موريتوري” بمعنى “الذين سيموتون” (وهو مأخوذ من قولة لاتينية “أيها القيصر، الذين سيموتون يحيونك”، وكان استعملها قبله المخرج السويسري برنهارد فيكي عنوانا لأحد أفلامه) ولم يكشف عن هويته إلا عام 2000، أي بعد أن وجدت أعماله صدى طيبا لدى القراء والنقاد. حاز شهرة عالمية بفضل رواياته البوليسية التي ينتقد فيها التزمت والصراع على السلطة، وبفضل أعمال أخرى كـ”سنونو كابل” و”الاغتيال” و”صفارات إنذار بغداد” عالج فيها حوار الصم بين الشرق والغرب. وقد ترجمت أعماله إلى أكثر من أربعين لغة وحوّل أغلبها إلى أفلام سينمائية ومسرحيات.
في كتابه الجديد “ما يدين به السراب للواحة” يروي ياسمينة خضراء حكايته مع الكتاب والصحراء والناس، حكاية تقاسم وحب قديم قِدم العالم، حب الحلم. يروي علاقته بالصحراء وهو الذي رأى النور في واحة كنادسة بولاية بشار، حيث ولد بيير رابحي من قبله، ويأخذ القارئ إلى شسوع الأمكنة، القاحلة في الظاهر، الحية في الواقع، حيث الموسيقى تضبط إيقاع الشعر، والسراب يتمخض دائما عن واحات.
كمال داود ناكر أصله
هو محبوب الإنتلجنسيا الفرنسية بلا منازع، والفضل ليس في روايته “مورسو-تحقيق مضاد” التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة غونكور عام 2014، بل في مقالاته المعادية للعرب والمسلمين وللغتهم ودينهم التي دأب على نشرها أسبوعيا في مجلة “لوبوان”، وجمعها في كتاب صدر هذا العام بعنوان “استقلالاتي”. تلك المجلة اليمينية التي أفردت له أحد أعدادها لتصفه في غلاف تتصدره صورته بـ”المثقف الذي يهزّ العالم”، وهي تعلم أنها تستغله لتثبيت الصورة التي يحملها الغرب عن العرب والمسلمين، مثلما تعلم أن أيّ واحد من محرريها لا يجرؤ على كتابة ما يكتبه داود خشية الملاحقة بتهمة العنصرية ومعاداة الإسلام. كنا نجد له العذر لو خصّ الراديكاليين والجهاديين بنقده، ولكنه يعمّم مآخذه على العرب والمسلمين أجمعين، غلاة ومعتدلين، بل إنه ينكر وجود العرب أصلا، فلا يأتي على ذكرهم إلا بوضعهم بين معقّفين أو بقوله “أولئك الذين يقال لهم عربا”، فإذا هو كمن يشتم أمّه لأنها أنجبت أخا لا يحتمل رؤيته. لقد بات هذا “المثقف” عَلَمًا يُستشهد بأقواله، ويدرج في ملفات عن قضايا فكرية هامة جنبا إلى جنب مع فولتير وروسو ومونتسكيو وسبينوزا ونيشته وسواهم، لا عن عمق تفكير أو جدّة مفاهيم أو حسن تحليل، بل لمجرد أنه يقول علنا ما يهمس به أعداء العرب والمسلمين في الفضاءات المغلقة، كدعوته الغرب إلى تعليم المهاجرين العرب قيمه الأخلاقية والحضارية قبل تمكينهم من تأشيرة دخول، وكأنه الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي! ولا ندري هل يتساءل عن سرّ تلك الجوائز التي انهالت عليه مرة كأحسن صحافي (مقالات رأي)، ومرة كأحسن كاتب (رواية مستوحاة من رواية أخرى)، ومرة كأجرأ مثقف (الخروج من جلده وشتم بني قومه وإنكار أصلهم وفصلهم) وهو لا يلتزم حتى الأمانة العلمية. ففي حديثه عن هوس المسلمين، دون استثناء، بالجنس، يتجاهل ما يجري في فرنسا نفسها من جرائم اغتصاب مشفوعة في الغالب بالقتل، وفي إدانته لزواج القاصرات يصمّ أذنيه عن الجدل القائم في فرنسا حول تخفيض سن القصور إلى ثلاث عشرة سنة، بعد أن برّأ أحد القضاة مرتكب جريمة اغتصاب طفلة في سن الحادية عشرة بأن ذلك تم برضاها.
شبيه به جزائري آخر هو بوعلام صنصال وكان قد شبه الإسلاميين بالنازيين فرضي عنه اليهود وكرّموه في القدس، وضمنوا له الحضور والانتشار والجوائز في أوروبا وخارجها.
بقي أن نقول إن اهتمام اللجان الفرنسية المتزايد بمؤلفات العرب الفرنكفونيين يتم في الغالب حسب المواضيع المطروحة أكثر من قيمتها الأدبية الصرف، وهي في العادة مسائل اجتماعية كالمثلية وزواج المثليين كما في رواية “الجدير بالمحبة” للمغربي عبدالله الطايع، أو دينية كالكفر والإلحاد كما في رواية “الرب، الله، أنا والآخرون” للجزائري سليم باشي، أو سياسية كرواية “مضحك الملك” للمغربي ماحي بينبين، وكأن الاعتراف بأولئك الكتاب يأتي من خارج الأدب.
أما الكتّاب العرب من ذوي اللسان العربي، ولا سيما المنحدرين من المغرب العربي، فلا حضور لهم إلا في القليل النادر، حتى بعد ترجمة أعمالهم، وكأن ثمة نية لدفعهم إلى تبنّي الفرنسية، في إطار استراتيجية عامة تهدف إلى حفاظ فرنسا على مجال نفوذها المهدد من كل جانب.
