في البدء كان الارتحال: رّحَالة ليبية منسية

لم يكف منظرو الفلسفة والاجتماع متأملين في مقاربة “الإنسان” وتقابله مع من قاسمه العيش المشترك ومن محيطه الأقرب، فوفق معطيات وتعليلات، تبريرية مُقرنة، جرى وصف أنه حيوان ناطق / مكاني / اجتماعي/ سياسي (أرسطو)، حيوان رامز (كاسيرار)، وحيوان مدني بالطبع (ابن خلدون)، حيوان أيدولوجي (نيتشه)، حيوان ميتافيزيقي (شوبنهاور)، فهل يُجاز لنا أن نضيف (حيوان رحلي)، كون الخصيصة البشرية في التنقل من مكان إلى آخر كانت عنوانه وديدن عيشه الحياة، توازى الإنسان مع الحيوان مرتحلا بحثا عمّا يسد رمقه كلأ ومرعى، فهل كان الإنسان حيوانا مرتحلا قبل أن يصير الناطق، الاجتماعي، الرامز، المدني، الأيديولوجي، وغير ذلك. وهل لنا نفي أنه في ترحاله القريب والبعيد شكل خبراته، وتكشف معارفه، ووجهها كلما أشبع حواسه بما حوله من الطبيعة، وتواصل مع صنوه الإنسان تارة صديقا، وتارة عدوا يصارعه على المرعى، والأنثى.
احتلت الرحلة بين الأسطورة والواقع التدوين، فصل ذلك “الترحال” العام، عن الترحال الخاص، العام مبتدأ فعل البشرية، الخاص الذي هو قرار بمحض الإرادة للمرتحل / الرحالة، في إحالة لما سيسمى تصنيفا أدب رحلات، وهو أيضا سيشهد تصنيفا أو تمييزا نوعيا، كأن نشير بتوصيف السندباد للرحالة (الأسطوري) شاهد الأعاجيب والخوارق الطالع من سيرة ألف ليلة وليلة، كما من فم المارد، والحوت الأزرق، فيما يصير توصيف ابن بطوطة (المغربي) لرأي العين، والانطباعات ذات الموثوقية، حتى وإن أخطأت تأويل مشاهداتها، ابن بطوطة من سيكتب أن زوجته الهندية رفضت الرحلة معه فطلقها بعد عِشرة ثماني سنوات في بلدها، لكنهُ يحيطها ويحيطنا بزوجات مرتحلات لا يفارقن أزواجهن عند السفر.
الرّحالة المشافهة
عني التراث العربي والعالمي بأدبيات الرحلة والرحالة، وهيمنت مدونات الرحالة الرجل، وغابت الرّحالة، فيما جرى تعليله بأن الأنثى / المرأة كائن ينحو الى الاستقرار، وهي الأصل في ذلك مع مبتدأ مجتمعات رعوية وزراعية، هو يرحل، وهي تستقر، ووسمت بالأرض، والوطن، والبذرة والحاضنة، وأنها الأصل في خلق ودوام الحياة بالمكان، غير أن ما يلفت الانتباه، ويطرح السؤال، لما أشيع أن المرتحل ذكر منفرد دوما؟ ألم ترافقه امرأته؟ على ذلك هي قسيمه في رحله أينما حل، الانتقال من مكان إلى آخر ظاهرة حياتية ظلت عنوانا لمجتمع البداوة، فهل انحازت هي للشفاهي فكانت الساردة (الراوية)، وصار هو المدون، فحفظت لنا تلك المخطوطات والرقن، وذرت الرياح ما باحت به شفاههن، أليست شهرزاد الحكاية مرتحلة ببقاع بغداد، والهند، ومصر، وتجيد وصف أناسها كما ميزاتها عمرانا وثراء وأعاجيب للناظر، هو إذن في جانب منه صراع الشفاهي (الأنوثة)، مع الكتابي (الذكورة)، إلى أن يحط على الورق كضمان ومصداقية لأيّ أرث يتوارث، المرتحل الذي يدخل إضبارة التاريخ وذاكرته، من يدون ويُعلم الآخرين، ومن ارتحل وسكن لن يُعترف برحله، النساء ضمن هذه المعايرة والقياس.
ولعل الباحث في مدونة الرحلات لن يعدم بالقطع وجود المرأة في مدونات الرحالة خاصة ما تعلق بأدائها شعائر الحج كسيرة رحلة السيدة عائشة ورفيقاتها، أو رحل المهمة والدور السياسي كالحاكمة قوت القلوب، وهي تغادر مصر إلى بغداد، وفي العصر الحديث تبرز سالمة بنت سعيد بن سلطان الأميرة ( البرنسيس إميلي روث) التي تزوجت ألمانيا، وكتبت “مذكرات أميرة عربية” في عرض ليوميات ترحالها من زنجبار، إلى إسبانيا، ثم ألمانيا ولندن.
تاء التأنيث تجوبُ ليبيا
في المدونة الرحلية عن ليبيا تحضر الرّحالات في زمن بين قرنين، ولعل اللافت فيما أتيح مما ترجم ولم يترجم، أنهن رحالات مُرافقات أو قريبات، ممن عملوا بسلك دبلوماسي سياسي، نموذجهن أقدمه، وأشهره أيضا، كمرجعية عن جغرافيا محددة هي مدينة طرابلس وضواحيها، “مس توللي” وهي شقيقة القنصل الإنجليزي ريتشارد توللي الذي مارس عمله في ولاية طرابلس، كتابها “عشر سنوات في إيالة طرابلس 1773 – 1783″، بمتنه الذي يقارب الخمسمئة صفحة، يمثل مخزونا أنثربولوجيا، سوسيولوجيا، وكشفا لمسكوت عنه، إذ وثّقت لأحداث ووقائع هي تفاصيل حكايا صراع بلاط القصر للأسرة القرهمانلي، الولاة من حكموا على التوالي حسن، أحمد، يوسف ووالدتهم للاّحلومة، وعلاقتهم بزوجاتهم، وعالم الجواري وخدورهن، “توللي” عايشت عادات وتقاليد، ومناسبات المكان أفراحا وأحزانا، وسجلت رصدها لأمراض أضرت الحرث والنسل، وسلوكيات أفراد السلطة، ورجل الشارع، ونساء المدينة القديمة.
أما مدونة رحلة الهولندية السيدة فان فرجيل “ست سنوات في طرابلس على الساحل المغاربي (1827 – 1833) فسيتكفل زوج ابنتها القس بيرك بجمع ونشر ما وثقته في إقامتها رفقة زوجها الدبلوماسي، القنصل الهولندي بطرابلس كليفورد كوك بروجيل، يوميات الأحداث الموصوفة بقلمها تدور نهاية العهد القرهمانلي، وبداية العهد العثماني الثاني، وما تضيفه فإن الهولندية عن مس توللي الإنجليزية، نشرها لتفاصيل العلاقة السياسية بين القناصل الأوروبيين والقصر الحاكم، وأدوار سفارات الدول وتنافسها في مسار تلك العلاقات، ولعل ذلك بسبب مقاربتها لوقائع مست سياسات المرحلة الانتقالية بين عهدين.
رحالة الصحراء الأولى أوروبيا كامرأة، الكاتبة الإنجليزية روزيتا فوربس (1890 – 1967) والتي حظي كتابها الأول “سر الصحراء الكبرى: الكفرة ” جنوب شرق ليبيا (1920 – 1921) بأكثر من ترجمة، كان أول رَحّلِها مع زوجها الى الهند وأستراليا، وبعد انفصالها عنه (1917) خططت للسفر على ظهر جمل، فاتحة عينها على وجهة أخرى الصحراء الكبرى، مرافقة للرحالة المصري أحمد حسانين باشا، وهي من شهدت أن لأهل الصحراء كرما مفارقا، نموذج ذلك ما درجه ساكنوها على منح فراش النوم، رفقة الطعام، والشاي، لكل ضيف عابر أو مقيم، ستعتني روزيتا بتدوين العادات والتقاليد، والأطعمة، والملابس التي ستنتقي زيا منها، وتصير أشهر صورها التي تُعرّف العالمَ بها لتبدو كامرأة عربية، وفي صورها ما يدلل على اندماجها في المحيط، وعيشها الواقع بما هو عليه، فما أعجبها أولا مفردات تعلمت نطقها وحفظتها ورددتها: تفضل، وكيف حالك، طيب،..، روزيتا ستنطلق مرتحلة وكأنها تحقق مشروع حياتها كرحالة في بلدان أفريقية، وآسيوية وأميركية، وستتوالى كتبها مضمنة سيرة رحلاتها تباعا، وستنجز كتابا مختصا عن قصص نساء قابلتهن في مجموع رحلاتها، وستعنونه ” نساء يُدعين جامحات”، وفي أثرها معادل لهن.
وكنت في دراسة أنثربولوجية عن واحة صحراوية بجنوب ليبيا (براك / الشاطي) طالعتُ كتابا بالإيطالية (إلى فزّان) صدر عام 1932 م، لرحالة جابت واحات متعددة والتقطت صورا مثلت نوادر ما التقط لتلك الجغرافيا، بل وتتفوق بكادرها، عنايةً مشهديةً فرجوية قياسا برحالة عبروا ليبيا مع مبتدأ القرن العشرين لم يهتموا كثيرا بالصورة، وثقت ذلك الإيطالية أونورينا بتروتشي زوجة الضباط الإيطالي الموظف بالقلعة العسكرية الجنوبية إبّان الاستعمار الإيطالي، ستنزل معه بقلعة براك / الشاطئ المركز الإداري لشريط واحات الجنوب، ثم تركب حصانها وتسوح الواحات (صحراء جنوب غرب) واحةً واحة، ومنها: آقار، برقن، براك، أدري، وما ميز كتابها والذي لم يترجم إلى العربية إلى يومنا هذا، هو كمّ الصور التي حفظت لأجيال لاحقة مناظر لم يعد لها أثر، ورحل معاصروها، كعيون الماء الجوفية وكثافة غابات النخيل وأماكن تعليم الأطفال وهي غرفة ملاصقة للجامع، كما أظهرت نساء خرجن مترافقات يحملن حطبا على رؤوسهن يتحركن بحرية في مساحة واسعة من المكان، وصورهن تظهر ملامحهن بوضوح، حين قمت بترجمة بعض من صفحات الكتاب، لفتتني الكتابة الشاعرية التي وصفت بها ليل الواحة وخرير المياه العذبة، بل إنها كتبت عن اكتشافها لما لم تعرفه قبلا “أن للضفادع إذا ما تجمعت معزوفتها التي تؤنس وحدة قمر ليل الواحة”!.
رحلات الرائدات الليبيات
مفردة الهجرة رحلة وعودة، خصيصةٌ ستجعل من المهاجرات الليبيات رفقة عوائلهن هربا من الفاشية الإيطالية مع مطلع القرن العشرين، علامة تاريخية فارقة لمن برزن كفاعلات في تاريخ نهضة النساء، إذ سيرجعن مؤهلات بالشهادات المتوسطة والعليا من بلدان أتيحت فيها فرص التعلم عندما كانت ليبيا ترزح تحت احتلال إيطالي في العقد الأول من القرن العشرين، جغرافيتها ساحة معتقلات، وإعدام صوري جماعي، ونفي إلى جزر إيطالية وقد مات أغلبهم في البحر، المرتحلات العائدات، الرائدات، كنّ مؤسسات وداعيات لولوج أبواب العلم والمعرفة، والعمل المتخصص، والمجتمع الأهلي والمدني، المعلمة جميلة الأزمرلي، والممثلة المسرحية سعاد الحداد عادتا من دمشق، صالحة ظافر من المدينة المنورة، ثم روما، تسنى السفر أيضا لبعض من الليبيات في مدن المراكز للدراسة والعمل، ففي عام 1912 كانت الشابة حميدة العنيزي قد التحقت من بنغازي بمعهد المعلمات المسلمات بتركيا قاطعة رحلة مخرت عباب البحر مع والدها، لكن سفرها اللاحق مترددة على مصر في الأربعينات ستقطعه وحيدة، وفي إحداها ستجلب معلمات لأول مدرسة رسمية للبنات عقب الحرب العالمية الثانية (1946م)، وفي ذات هذا العقد ستقفل فتحية عاشور عائدة من جامعة القاهرة بشهادة في اللغة والأدب الإنجليزي ما سيؤهلها بجدارة لتصير أول مديرة لمدرسة بقلب مدينة درنة (شرق ليبيا)، والتي سيذكرها المؤرخ اللبناني نقولا زيادة في رسائل لزوجته مضمنة بكتابه “رسائل من برقة” (برقة الولاية التي عمل بها نائب مدير المعارف). ولن ننسى رباب أدهم، وماجدة المبروك اللتين كانت وجهتهما الجامعة الأميركية في بيروت (1959،1958م)، وستدون رباب سيرتها ورحلها التعليمي والحياتي في كتابها (دروب في الحياة – 2012) فهي ابنة المرتحلين أبا عن جد، ولها منه نصيب ولادة، ونشأة، وسني شبابها، من إسطنبول إلى سوريا، ثم الأردن، فبيروت، فمصر وإيطاليا.
رحالة منسية
لكن الرحالة المدونة منتصف القرن المنصرم “خديجة عبد القادر الشريف”، أصيلة طرابلس القديمة، الشابة العشرينية، من ستركب طائرة إلى القاهرة مفردة في أول ترحالها عام 1956م، كان محيطها ينظر للمرأة بعين الريبة وكيل التهم، فمع أول عقد استقلال البلاد بجهود واعتراف دوليين، ومعافرة آباء مؤسسين، بأن لا رجعة دون وطن موحد الولايات، ومتخلص من هيمنة إدارية استعمارية، حاذتها أوضاع مخلخلة هشة هي ارتدادات، نتاجها شعب تقاذفه المرض والجوع والفقر والأمية، وفي رصد لعدد المتعلمين من الذكور في خمسينات أول الاستقلال (1951) عُدوا بضعة عشرات نتاج مدارس محلية وتعليم إيطالي، ولن تعرف ليبيا مؤسسة “الجامعة” حتى مضيّ سنوات من استقلالها.
خديجة ولدت عام 1938م ببيت كان يقطنه وال عثماني قبل قرن من ولادتها فيه برحاب المدينة القديمة، والدها التاجر عبدالقادر الشريف، ووالدتها “فاطمة “، تيمة أشعار ابنها الشاعر المجدد الحداثوي الموسوم في مدونة ببيلوغرافيا الشعراء الليبيين، بشاعر الحب، والشباب، والوردة الحمراء، علي صدقي (اسمه مركب)، المناضل والمحامي، وشخصيته كما شعره أثارا جدلا فهو من حاملي مشعل الخلود وأن لا فناء لشاعر، وهو الذي بدعمه ودفعه بل إيمانه بقضية تحرر المرأة من ربقة التقاليد والعزلة سيجعل من أختيه (زينب، وخديجة)، ثم ابنتيه (أحلام، وتماضر) نماذج ريادية في مجالات العلم والأدب والعمل المدني.
إلى المنوفية مع الفلاحات
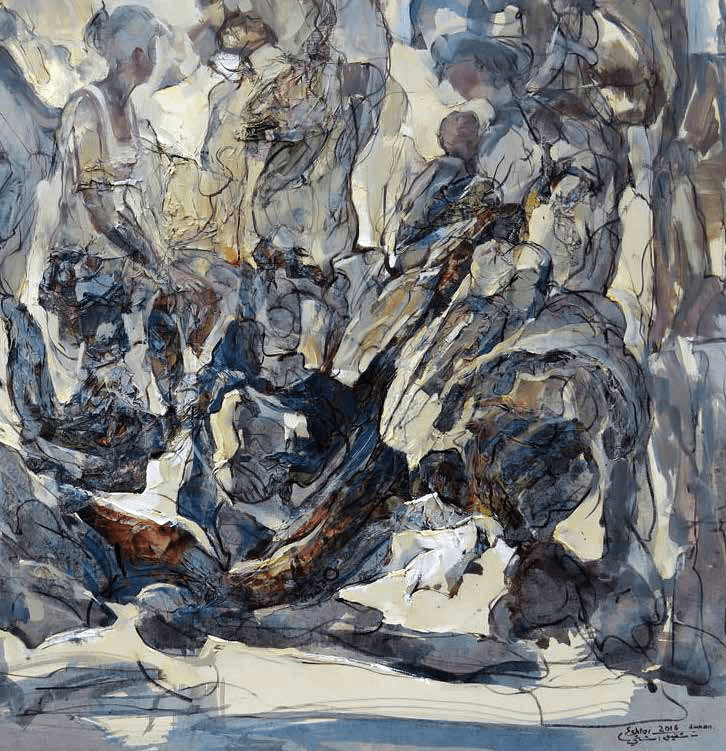
تقدم خديجة مسرودها عن رحلتها التعليمية الأولى إلى مصر، في كتابها “المرأة والريف في ليبيا”، وقد جاءت مقدمة الكتاب إهداء من مدير المعهد مصطفى سعيد قدري الذي سينوه فيه بشخصيتها المجدة والمثابرة، كما وسيثني على جعل أطروحتها كتابا بكرا في بلدها حول تنمية المجتمع متخصصة في أوضاع المرأة الريفية. وفي خارطة الكتاب أنه فصلان، الفصل الأول سيحوي سيرة الرحلة الدراسية التي أوفدت لها خديجة المعلمة التي تواصل دراستها العليا، أول الصفحة ستحكي لنا عن هواجسها أول ركوبها الطائرة وحيدة، وما يدور في رأسها من أفكار، وما يعتمل في نفسها من رهبة وتردد، لكنها تستقر على أمرها خارقة كل الحواجز النفسية كونها صاحبة مشروع ورائدة فيه، ولن تخيب أمل طالبات علمتهن في المدرسة الابتدائية، ولا من جالستهن في المكتبة حين أدارتها، فتكتب “سمعتها تهيب بي بحرارة، طالبة مني أن أردد صوتها، وأروي قصتها وأتحدث عن قضيتها.. لذلك اتخذتُ من رسالتي هذه صدى لصوتها ومن حقها عليّ، وهي أختي أن أجعل من رسالتها رسالتي”، ستجعل أطروحتها عن نساء مهمّشات، وقد أُتيح لها وضمن ما كان مقرراً من منهج نظري في معهد تنمية المجتمع، وتطبيقي تمثل في الزيارات المُكثفة داخل مصر، والتي شملت القرى الفلاحية النموذجية، ومقاربة لعلاقة الفلاحات بالأرض، ومستخدمة مفردات المكان في كتابها تشير الى الترعة والجاموسة وأكواز القصب، كما وتعرض مشاريع الحكومة المصرية لمساعدتهن وكيفية العناية بحقوقهن كمنتجات يتقاسمن ظروف العمل مع أزواجهن وأبنائهن، وتشير خديجة إلى أن الدروس العلمية العملية تطلبت السفر بحراً إلى بلاد مختلفة، فقد زارت اليونان ويوغسلافيا وإيطاليا، ولامست عن قرب تنوع تلك المجتمعات جغرافياً وأثنيا، وقد سجلت معايشتها المقتضبة لكثير من الأحداث والمواقف المتنوعة بل والمتناقضة أحياناً!
خديجة في بلاد العجائب
إلى إنجلترا ستشد الرحال في اغترابها الثاني (1961 – 1962)، وستدونها تحت عنوان “انطباعات ليبية في بلاد التقاليد والثلج والضباب”، في سلسلة مقالات نشرتها فور عودتها من لندن بالجريدة اليومية طرابلس الغرب. لا تتمركز عين خديجة فقط في المكان والمعالم التي زارتها من كنائس ومتاحف وميادين ومسارح وسينما وحدائق شهيرة ومدينة شكسبير(سترات فوردان أفن) أو كما اعتدنا في مدون الرّحل، بل تقارب شخصيات تتعاطى معها في يومها وتصف سلوكها أو علاقتها معها، من بائع الجريدة في الكشك حين تنزل من سكنها، إلى بيت الطالبات وزميلاتها تشكيلة من جنسيات العالم الملايو وأندونيسيا وإيران وتركيا وأميركا، وتسرد لنا حكاية تعرّفها على الأميرة عائشة ابنة ملك المغرب الراحل محمد الخامس بالمركز الثقافي الإسلامي بلندن في التجمع العربي الإسلامي في حفل عيد الفطر.
وتخفف من دسامة معروضها عن معالم المكان بطرائف تلتقطها مُذ نزلت أول يوم لها ببيت الأسرة التي ستقيم عندها في “أكسترا”، إذ حدثتها ربة البيت عن كلبها الذي مات وخصاله النادرة التي لم تجتمع في كلب غيره – كما تقول – وأنه ينحدر من أسلافه المعروفين العريقين في النسب، وتجمع لنا طرائف متبادلة بين الإنجليز والأسكتلنديين والفرنسيين.
ومن ضمن يومياتها خروجها إلى “الميدان الأغر” متتبعة مسيرة شعبية يتقدمها الفيلسوف المفكر “برتراند راسل” في دعوته وأنصاره من الطبقات الشعبية إلى السلام ووقف الحروب، وتضع عنوانا “بريطانيا تسجن السلام حين تعاقب راسل”، ومما كتبت “…وسجنت بريطانيا السلام، ووجد الفيلسوف نفسه في سجنه حراً، كما لم يكن حراً من قبل، واتسعت جدرانه، لتحتضن كلمات الناس الطيبين الذين انهالت برقياتهم عليه، بعد أن أذابت أقفال الحديد والأسوار العالية، لتستقر بين يديه كحكايات حرة تتحدي أسوار السجن والسجان”.
وتصف بإعجاب تقسيم الوقت عند المرأة الإنجليزية بين عملها وبيتها ونصيبها في المطالعة والدرس من أجل الثقافة العامة، وهي لا تنسي أيضا الترفيه عن نفسها. لكن خديجة تنتقد نظرة شمولية حملها الإنجليز والغرب عموما عن البلاد العربية جازمين أنها صحراوية لا تنبت شيئا، “تتجول النمور والأسود والفيلة في مدنها، وتعيش مع الإنسان العربي بموجب معاهدة غير مكتوبة، وأن العرب أميون!”.
ومن حديقة الهايد بارك تنقل لنا قصص عدة، حيث الخطباء والفرق الموسيقية والمشاهد الغريبة والرقصات والأغنيات الفولكلورية، منهم حملة الرأي الصادحون بمسكوتهم أحد كل أسبوع، المنتقدون للحكومة ووزرائها، وعندها أن لندن عاصمة المفارقات التي تمد لسانها بوجهها الساخر، ففي الجريدة اليومية تقابلها صفحة إعلان لحانوتي يبيع توابيت الموتى وبجانبه صورة عارضة أزياء تعلن عن أجمل فستان لعروس الموسم تشق حياة جديدة به.
عامها في لندن جعلها تنخرط في نظام الطوابير من محطات الباص وأمام بوابات المحلات العامة في تحضيرات حفل رأس السنة، وتعلمت أن تنتظر دورها من غير ضجر أو تبرم، على أن تصحب كتاباً أو صحيفة أثناء انتظار دورها، فلا مفر الطابور هو كل شيء في حياة الإنجليز، وما تفتأ تشير إلى مدلولات الثلج والضباب والتقاليد من جمود وصلادة في مجتمع الإنجليز، كونهم على استعداد لأن يخالفوا العالم كله في أي نظام إن وجدوه يغير من عاداتهم وتقاليدهم.
المطالع ليوميات ليبية في بلاد الإنجليز لا يعدم الانتباه إلى وعي خديجة بالمسألة النسوية، فهي تحمل هموم المرأة منشغلة بقضاياها، بقلب لندن ستحاضر عن المرأة ودورها في ليبيا في جمعية التاج النسائية، وقد منحتها مسؤولة الجمعية توسيما كعضو شرف، وقد علموا بنشاطاتها النسوية في طرابلس، وستجري معها مقابلة محطتا “بي بي سي” العربية والإنجليزية، وحوارا مع جريدة صن داي، وعن بروز وعيها وموقفها القومي ما عبرت عنه حين دعت صديقتها الإنجليزية لمرافقتها إلى المؤتمر العربي المنعقد في 13- 5 – 1962م بمدينة لندن من أجل فلسطين، والذي شارك فيه الطلاب العرب وسفراء الدول العربية في بريطانيا والجاليات العربية والإسلامية هناك، كما حضره مناصرو القضية الفلسطينية من الإنجليز وغيرهم.
وتستوقفها ظاهرة سنوية وهي هدية شجرة عيد الميلاد من الدنمارك الى إنجلترا، ما يجعلها تدعو إلى ما أسمته تبادل “الرمز الأخضر” كعربون وعنوان سلام بين البلدان العربية، مقترحة أن يكون حفنة تراب من بقعة معركة ونضال، أو شجرة يجري غرسها، أو أثر تاريخي.
خاتمة
في كتابها “السير الذاتية النسائية في الأدب المعاصر” تضع الباحثة السعودية أمل التميمي هامشا تشير فيه الى خديجة عبدالقادر، وعن مطالعتها ليوميات ليبية في بلاد الإنجليز في كتاب “رحلة القلم النسائي الليبي” للباحثة الأديبة والأستاذة الجامعية شريفة القيادي، وكنت أثناء انشغالي بجمع حلقات يومياتها ببريطانيا من جريدة طرابلس الغرب، لإصدارها في كتاب كأول أدب رحلات تنتجه كاتبة ليبية، اتفقتُ مع إشارتها، أن في منتج خديجة ملامح من سيرة ذاتية إذ تكتب ذاتها الناهضة، ورأيها في قضايا بلادها بعامة والمرأة بخاصة.
